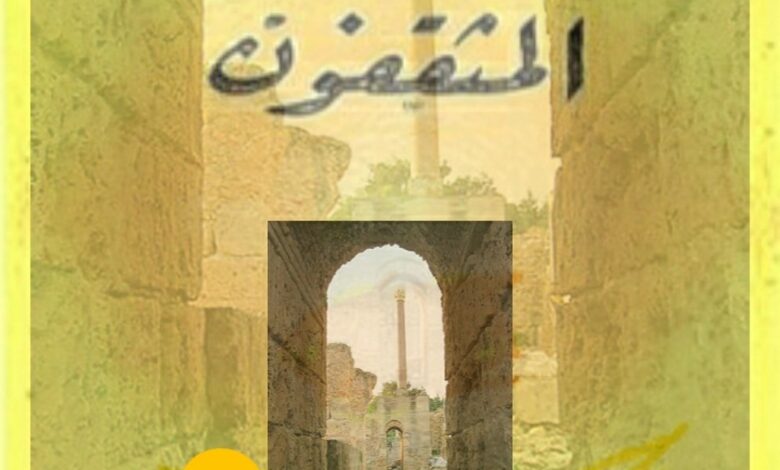
خاص الطائر – تونس
بقلم محمد الخزري
وسط دغل من أشجار الأكاسيا يرسو جسر صغير، هو ليس بالجسر إنما معبر بالكاد تمر عبره سيارة واحدة ومترجل واحد، وتبرز أعمدته الصدئة بين أعواد القصب المتنامية على ضفتي الوادي، وادي “الرغّاي” وهو رافد من روافد نهر مجردة أكبر نهر في تونس، الجسر منخفض إذ يكاد يلامس سطح المياه الراكدة تحته، وهذا ما جعله مكان مغري للوقوف على جانبيه والتأمل ومكان خصب لرعي المواشي والدواب والخيول، أمر دفع حكيم لجلب حصانه للرعي والوقوف للتأمّل.
بسط حكيم مرفقيه على عارضة الجسر وأراح ذقنه على ظهر معصميه وسحب نفسا عميقا وأطلق العنان لنظراته تجوب الأرجاء ولذاكرته للسفر بعيدا، ذاكرته التي توقفت قبل ثلاث سنوات وهي المدة التي قضاها في السجن الذي غادره منذ بضعة ايام، حيث توقفت عجلة الزمن بالنسبة اليه خلال تلك السنوات. لم يبقى في روح حكيم من السجن سوى ومضات لا تتعدى الثواني أو اللحظات، روتين يومي ممل، حسن المعاملة من قبل الإطارات السجنية، المشاركة في بعض الأنشطة الثقافية او محاولات أحد مديري السجن لاقناعه باكمال رسالة الدكتوراه في التاريخ القديم حيث وعده بأن يأخذه إلى أي موقع أو متحف أثري في كامل البلاد للقيام بالدراسات وتوفير المراجع والكتب التي يريدها، لكن حكيم فقد الشغف والحماس للتاريخ القديم الذي كان منذ صغره يعشقه كثيرا.
ليس السجن وحده من أفقد حكيم الرغبة في إكمال دراسته، انما معاناته أثناء تحضير مذكرة ختم الدروس وتأخره في الحصول على الماجستير في التاريخ من كلية العلوم الانسانية، فقد اجتهد وقدم شيئا مميزا ومختلفا اذ استعان بفرقة مسرحية شبابية لتقديم عرض مسرحي كوثيقة داعمة لمذكرته، فكرة عبقرية أراد أن يغير بها نمط آلاف المشاريع والمذكرات التي يقدمها الطلبة عند تخرجهم من الجامعات، لكنها قوبلت بالازدراء والتبخيس من قبل المؤطرين والأساتذة، فقد كان هدفه ابراز دور المسرح في الحضارة القرطاجية محاولا إثبات تأثير المسرح الإغريقي فطلبت منه ادارة الجامعة توثيق العرض المسرحي في حامل الكتروني وهذا ما تطلب منه جهدا كبيرا بين أروقة الوزارات ومختلف الهياكل كما تعمقت معاناته في الحصول على تراخيص الدخول والتصوير في المواقع الأثرية، ومع ذلك تمكن بعد إصرار ومثابرة من تحضير رسالة الماجستير في التاريخ القديم ويوم تقديم عمله أمام اللجنة العلمية نظر له رئيس اللجنة، وهو دكتور جامعي معروف بظهوره الإعلامي المكثف ونشاطاته الجمعياتية في مجال حوار الحضارات، نظرة متعالية وقال:”ولدي أنت تهز وتسبط، اركح يعيش ولدي يزي من حكايات حي درابك” بلهجة تونسية مستفزة ويعني بكل بساطة أن عمله “لاشيء” فأحرجه أمام أهله وزملائه وأصدقائه الحاضرين للاحتفاء به، معاملة مهينة يقوم بها كبار القوم في بلادنا تجاه الشباب للحط من عزائمهم وإحباطهم ثم يتساءلون بسذاجة عن سبب هروبهم من البلاد.
في وقت لاحق أعاد حكيم صياغة مذكرته كما تريدها إدارة الجامعة وانساق وراء السائد وتحصل على شهادته وعاد إلى قريته الصغيرة وسط الحقول وآثار الغابرين، غير بعيد عن المواقع الأثرية بشمتو وبلاريجيا شمال مدينة جندوبة، حيث هناك بدأ ولعه بالآثار والحضارات القديمة، هو من أسرة كبيرة يقال أنها من قبائل تونس الكبرى التي استوطنت في الشمال الغربي للبلاد حيث الماء والكلأ، هو في الواقع كل تونسي تسأَله عن جذوره يقول أَنه من “َجلاص” أَو “أولاد عبيد” أو “الفراشيش”َ الخ…..كي ينسب لنفسه مجد أسلافه مقاومي الاستعمار، وأسرة حكيم تقليدية لم تتشوه بعد بحب المال والبنايات الفخمة والسيارات الفارهة، انما ثروتهم أرضهم وخيولهم الأصيلة مصدر فخرهم ورزقهم اذ يشتهرون بتقديم العروض في الأعراس والمهرجانات الشعبية.
لما شعر بوطَأة البطالة قرر حكيم الشروع في إعداد رسالة الدكتوراه حيث لم يكن عمله في الزراعة مع أهله كافيا لملئ الفراغ بداخله، كما تعرف على شاب من القرية المجاورة هو في الواقع كهل تجاوز الأربعين بسنوات لكنه يعتبر نفسه شابا لأنه أعزب ومعطل عن العمل رغم حصوله على الأستاذية في الفلسفة من كلية العلوم الإنسانية منذ حوالي عشرين عام، وقد كان لبيب تقريبا الجليس الوحيد لحكيم في المقهى، حيث كان الحوار بينهما راقي ومميز، ويختلف عما يدور في المقهى من نقاشات سطحية مستمدة من السجالات السياسية البافلوفية التي تبثها وسائل الاعلام ، فالحوار بينهما عميق يدور حول التاريخ والحضارات والعلوم، حيث كان لبيب يقول لحكيم دائما:”أوصيك أن تكون مؤرخا ذا ثقة ومصداقية مثل “هيرودوتس” الذي كان يتلوا أعماله أمام الجماهير في مهرجانات “أولمبيا” الشعبية في اليونان، وأنا لا أثق في أي مؤرخ غيركما” . كلام ثري ومفيد، لكن على أرض الواقع كانا محل سخرية من رواد المقهى، نظرا لكونهما ليسا من أصحاب المال والمناصب، كذلك لأن الناس لا يحبون الثقافة والرقي ولا يحبون الكتب ولا المسرح ولا الموسيقى لأنها أشياء لا تغني من جوع.
لم يستأنس حكيم البطالة كثيرا فقرر إنشاء مشروع مربح يعطي قيمة للتاريخ وللثقافة، فأسس استراحة على الطريق الرئيسي تقدم الأكلات التقليدية للزوار والمسافرين وبعض هواة الرحلات الجبلية كما استعان بوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعه فكانت البداية واعدة كما وجد من يستمع إليه ويعطي قيمة للتاريخ والحضارة والثقافة، لكن فرحته بمشروعه لم تدم طويلا حيث جاء عام 2020 بمفاجأة هزت أركان العالم، إنها “الكورونا” التي أوقفت كلّ شيء وأحالت الجميع على البطالة، بطالة استفاد منها فقط الموظفون في الدولة وبعض التجار والمهربين، ورجع حكيم للبطالة من جديد وصارت لقاءاته بصديقه لبيب وسط الحقول بعد شراء القهوة خلسة من المقهى المغلق بسبب الحجر، في تلك الفترة استفحلت ظاهرة البحث عن الكنوز والآثار في المنطقة، وهي ظاهرة منتشرة في كامل البلاد منذ زمن بحكم رغبة الناس الدائمة في الربح السريع والثروة السهلة،َ حيث زادت “الكورونا” في تعميق هذه الرغبة، وهذا ما جعل لبيب يقنع صديقه حكيم بالبحث عن الكنوز مثل باقي الناس في القرية والاستفادة من معرفته بالآثار، فوافق حكيم رغم خطورة الأمر وصارا يمارسان نشاطهما كلّ ليلة، وأهمل مشروعه ولم يعد يساعد أسرته في الزراعة وأصبح ينشط ليلا وينام في النهار مثل اللصوص، وذات ليلة وجدا موقعا بين مقطع الرخام والنهر، وقد تأكد حكيم أنه مقرّ المحاسبات الذي يتم فيه خلاص شحنات الرخام التي يتمّ نقلها عبر نهر مجردة إلى أوتيكا ومن هناك يقوم القرطاجيون بتصديره عبر المتوسط نحو روما والجزر اليونانية وميناء صور في الشرق، فقاما بالحفر بطريقة علمية رغم أن لبيب حاول مرارا اقناع حكيم الاستعانة بعرّاف كما يفعل الآخرون في بحثهم عن الكنوز، ومع ذلك عثرا على أشياء ذات قيمة وهي أواني قرطاجية عليها نقوش، وبسرعة تعرف عليها حكيم وقال:”هذه الأواني يقدم فيها الطعام لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يأتون للمحاسب لمراقبة عملية التصدير والتوريد والقروض والهبات”، فأجابه لبيب:”هذا دور المجالس المحلية، هذه المنطقة كانت تمارس الحكم المحلي”، احتدّ النقاش بينهما في جنح الظلام حول نظام الحكم في البلاد خلال الحضارة القرطاجية، حيث قال حكيم:”الحكم المحلي كان صوريا لأن حنبعل قرر وحده معاندة روما وترك قرطاج وأهلها”. لم يرض لبيب بالأواني وأصر على الاستعانة بساحر أو عرّاف للعثور على جرّة مليئة بالذهب فاحتدّ النقاش مرة أخرى وغادر لبيب المكان بحثا عن عرّاف، في تلك الأثناء مرّ بجانب الموقع مجموعة من الموظفين والإطارات السامية في المنطقة ، كانوا في رحلة صيد ضاربين عرض الحائط قوانين الحجر الصحي وقوانين الصيد البرّي، ورحلات الصيد البرّي موضة اجتماعية في كامل البلاد حيث ينظمها الأعيان، وبسبب الجلبة التي أحدثها لبيب وحكيم بنقاشاتهما الثقافية تفطن لهما الصيادون بسهولة، حيث كان من بين الصيادين إطار أمني وقاضي كبير في البلاد وسياسي معروف، فأوقفوا حكيم بواسطة بنادقهم واتصلوا بدورية أمنية لتكون الأمور رسمية والإجراءات قانونية ليجد حكيم نفسه موقوفا على ذمة التحقيق في قضية خطيرة في زمن الكورونا، والمحاكم مغلقة والوضع صعب في السجون حيث انتظر حوالي شهرين ليمثل أمام القضاء في ظروف صعبة ويعاقب بثلاث سنوات ولم يسعفه تكليف محامي، فهو لم يكن يعلم أن في مثل هذه القضايا يجب تكليف محامي كبير ودفع مبلغ كبير كي يكسب القضية، لأنه في المحاكم التونسية حجم وثمن المحامي يعتبر أهم عامل من عوامل كسب أي قضية، كما عثروا في مشروعه الثقافي على مجلس من الحجارة الرخامية كان يقدم عليها القهوة والطعام للزبائن، وما زاد الأمر سوءا هو أنه في نفس تلك الليلة حدثت جريمة قتل بشعة لفتاة صغيرة في منطقة قريبة وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف وتبادل رواد المواقع صورته وحوكم آلاف المرّات على جريمة ليس له بها اي علاقة وتلذذوا بشتمه بالتعاليق والتدوينات التي تطالب بإعدامه وشنقه والتنكيل به، هكذا دون علم ودون معرفة، ومرّت السنوات الثلاثة في السجن رتيبة مملة حاول أن ينسى فيها التاريخ والنقاشات الثقافية التي كانت سببا في ازدراءه من قبل الناس في المقهى وكانت سببا في كشفه هو وصديقه لبيب والقبض عليه، حاول أن يتخيل نفسه غادر الدراسة مبكرا ولم يدخل الجامعة وصار مهربا ذا هيبة ووقار وثروة، لكن الثقافة كظلّه بقيت تلازمه في حتى في السجن.
بعد رحلة الذكريات رفع حكيم رأسه عن عارضة الجسر وتمسك به بكلتا يديه بقوة كأنه يخاف أن يقع أو أن ترفعه عاصفة عابرة عن المكان، ثم نظر لحصانه الهزيل الذي فقد الكثير من قوته ونشاطه بسبب غلاء الأعلاف وفقدانها أحيانا، ثم نزل اليه ورافقه وسط أرض محروقة بجانب النهر، حرقها صاحبها من أجل تسميدها برمادها غير عابئ بالحشرات والكائنات الصغيرة التي احترقت جحورها ومؤنها، فلمح في الأفق في آخر الحقل عشر بقرات سمان يسوسها صديقه لبيب فسلم عليه وعانقه وقال له:”لا تاريخ، لا فلسفة، لا ثقافة بعد اليوم”





